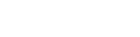مرة أخرى يلتهب النقاش حول المادة رقم 57 من قانون الأحوال الشخصية المتعلق بحضانة الطفل بين الزوجين المنفصلين، كانت آخر مرة، عام 2021 في البرلمان العراقي عندما حاول عدد من النواب تعديله، مما أثار انزعاج نواب آخرين يدعون الدفاع عن حقوق المرأة، وأن التعديل يظلمها، بينما الملاحظ بشكل موضوعي، أن الظلم يقع بالدرجة الأولى الى الطفل الذي يجد نفسه ممزقاً بين مدرستين للتربية؛ الأم المطلقة وعائلتها وزوجها –أحياناً- ومدرسة الأب وعائلته، بما يعني أنه (الطفل) يقع ضحية ليس فقط للطلاق، وإنما للقانون الذي تجاهل مستقبله.
قبل الخوض في الموضوع، جديرٌ بنا تقديم نبذة موجزة عن الخلفية التاريخية لهذا القانون، ففي عام 1959، وبعد سنة واحدة من الانقلاب العسكري بقيادة عبد الكريم قاسم، وتأسيسه للنظام الجمهوري لأول مرة في العراق على أنقاض النظام الملكي، فاجأ الشعب العراقي بقانون رقم 188 الخاص بالأحوال الشخصية، وبضمنه؛ المادة 57 الخاص بحضانة الطفل من الزوجين المنفصلين، وأعطى الحق للزوجة بحضانة الطفل دون الأب حتى سن الخامسة عشر من العمر، في محاولة منه –حسبما يُفهم من القراءة السياسية لتلك المرحلة- لمنح حقوق للمرأة كانت محرومة منها، وأن تستمر بدور الأمومة، وإن كانت مطلقة، ثم وإن تزوجت فيما بعد، بينما يحرم هذا القانون؛ الأب من رؤية أولاده إلا لساعات معدودة ضمن برنامج تديره المحكمة، كما لو أن المرأة العراقية كانت في تلك الفترة لم يكن ينقصها شيء من حقوقها إلا هذه، ولم تكن تعاني الجهل والمهانة!
الحوزة العلمية؛ بعلمائها وخطبائها، أعلنوا في حينها معارضتهم الشديدة لهذا القانون، و بينوا “للزعيم” آنذاك تعارضه مع الدين والعقل، فمن الناحية الشرعية لا تحلّ الفتاة لزوج أمها، ومن الناحية العقلية والمنطقية فان الابن يعود للأب، ويحمل اسم أبيه لا أمه، وأن المنظومة التربوية يحددها الأب بنجاح أكثر من الأم بما لديه من قدرات ذهنية، بيد أن “الزعيم” لم يصغ لأحد، وتجاهل الجميع، مصراً على موقفه من إقحام هذا القانون الجدلي في الدستور العراقي.
التحدي الخطير لا يأتي من هذه الجماعات المدافعة عن مادة قانونية تهدد كيان الأسرة العراقية، وإنما من منظومة ثقافية تلقي بظلالها الثقيلة على الواقع الاجتماعي والثقافي في العراق، مدعومة من مؤسسات إعلامية وحقوقية عالمية
لن نسهب في المآلات الكارثية لهذا القانون طيلة العقود الماضية على الأسرة العراقية التي وجدت أنها أمام جحافل من الأولاد من دون أب، بين منفصل بسبب الطلاق، او مقتول في الحروب الكارثية المتعددة، وهؤلاء الأولاد؛ من البنين والبنات يكبرون مع الأم المتزوجة –في بعض الحالات- فتحصل تقاطعات و تعارضات في الأخلاق والسلوك، ثم مشاكل نفسية وأخرى أسرية تنفجر أحيانا بشكل دموي، فيما تظل مشاكل أخرى مكتومة تحت الرماد أحياناً أخرى.
وما يجري اليوم من سجال في أروقة البرلمان، وفي خارجه، ليس على إلغاء هذه المادة كما كان مطلب المرجع الديني الراحل السيد محمد الشيرازي، وسائر العلماء والفقهاء في كربلاء المقدسة والنجف الأشرف، في تلك الأيام، وإنما لتعديلها فقط، وهي أن تقلل فترة حضانة الأم الى سبع سنوات، وأن تكون لوالد الزوج (الجد) الحق في الحضانة في حال وفاته، والامر الثالث الأكثر حساسيةً؛ انتفاء حق حضانة الزوجة في حال زواجها.
هذه التعديلات اثارت انزعاج أوساط ترفع شعار “المدنية” في ظل النظام الديمقراطي في العراق، ومن يدعون الدفاع عن حقوق المرأة، وأن هذا التعديل يسلبها حقوقها وأمومتها، فهم يقفون اليوم في جبهة متراصّة، وبكل قوة وإصرار يسعون لخلق رأي عام ضد تعديل هذه المادة، في الأوساط الثقافية والسياسية، مستفيدين من أي مناسبة، أو محفل او مجلس للطعن بهذا التعديل.
التحدي الخطير لا يأتي من هذه الجماعات المدافعة عن مادة قانونية تهدد كيان الأسرة العراقية، وإنما من منظومة ثقافية تلقي بظلالها الثقيلة على الواقع الاجتماعي والثقافي في العراق، مدعومة من مؤسسات إعلامية وحقوقية عالمية، يعضدها جهد سياسي من عواصم كبرى في العالم، في المقدمة؛ واشنطن ولندن وباريس، كما لاحظنا رد الفعل العنيف من السفيرة الأميركية في بغداد إزاء سن قانون تجريم البغاء والشذوذ الجنسي.
أمامنا خطوات عملية عديدة لأن نثبت حقانية تعديل هذه المادة، وقبل كل شيء؛ إبعاد الملف من المسار السياسي لأمرين؛ الأول: تحاشي الحماس والشعارات ونظرية المؤامرة، ومن ثمّ؛ التجاذبات الإقليمية والدولية، مما يبعد المسألة عن إطارها التربوي والثقافي، والأمر الآخر: تكريس الجهد الإنساني من مختلف شرائح المجتمع، وتوظيف كل الجهود للوصول الى أفضل النتائج، فالقضية تمسّ حياة كل فرد في المجتمع، لأن هذه المادة تمثل لغم خطير في الأسرة العراقية، مما يستدعي مشاركة الجميع بشكل او بآخر في هذا المسعى.
والخطوة المُكملة الأخرى؛ تظافر جهود الحوزة العلمية، بعلمائها وخطبائها، وجهود المثقفين والإعلاميين والشريحة المتعلمة للتثقيف على دور المرأة الحقيقي في الأسرة والحياة، ابتداءً من كونها فتاة صغيرة، وحتى مرحلة المراهقة، ثم النضج العلمي والذهني والنفسي وحتى مرحلة الزواج والانجاب، وشرح مكانتها المرموقة في النظام الاجتماعي في الإسلام، وهذا من خلال ندوات مفتوحة، وبرامج حوارية تبث في وسائل الاعلام، ومن خلال نشاط الحسينيات والهيئات والمحافل النسوية على وجه الخصوص، مثل الحوزات العلمية الخاصة بالنساء.
الحوزة العلمية؛ بعلمائها وخطبائها، أعلنوا في حينها معارضتهم الشديدة لهذا القانون، و بينوا “للزعيم” آنذاك تعارضه مع الدين والعقل
والخطوة الأهم الأخرى؛ الحثّ على تعليم المرأة وتوسيع معارفها ومعلوماتها من المصادر الأصيلة التي لا يأتيها الباطل من يديها ولا من خلفها وهي؛ القرآن الكريم وما خلفه لها الأئمة الاطهار من تراث فكري ومعرفي عظيم مثل نهج البلاغة، والصحيفة السجادية وغيرها من كتب الروايات والاحاديث والسيرة التي تقدم لنا منهجاً متكاملاً لحياة سعيدة بعيدة عن المشاكل والأزمات.
وبالمحصلة؛ أن تعرف المرأة أن هذا التعديل بعيد كل البعد عن ظلمها، إنما هو ينصفها ويحفظ لطفلها حقوقه في التربية والتنشئة الصحيحة لمن هو أقدر وأكثر إمكانية، دون أن تتحمل هي أعباء مسؤولية فوق طاقتها.